مراجعة رواية آلموت

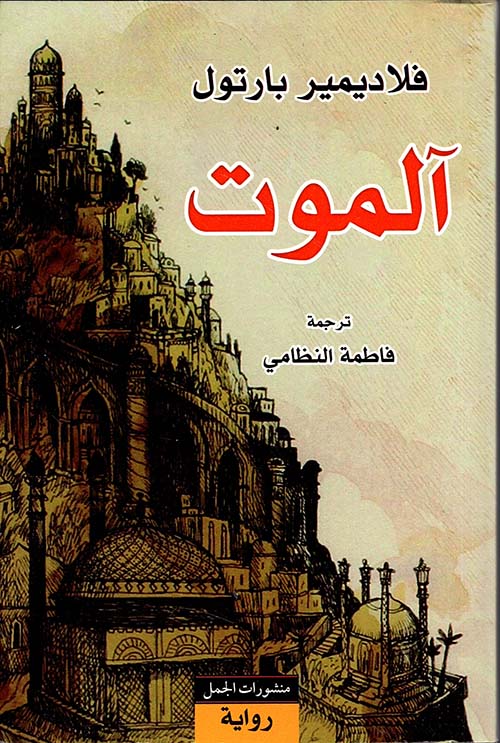
مراجعة شاملة
في أعالي جبالِ البرزِ الشاهقةِ، حيثُ تعانقُ القممُ السحابَ وتنعزلُ عن صخبِ العالمِ السفليِّ، شيدَ الكاتبُ السلوفينيُّ فلاديمير بارتول عامَ 1938 قلعتَهُ الأدبيةَ الحصينةَ ألموتَ. لم تكن هذهِ الروايةُ مجردَ سردٍ تاريخيٍّ عَابِرٍ، إنما كانت هي متاهةً فلسفيةً معقدةً، ووثيقةً سيكولوجيةً مرعبةً حولَ صناعةِ الطغيانِ، ودرسًا بليغًا في كيفيةِ تحويلِ البشرِ إلى أدواتٍ صماءَ. إنـها عملٌ أدبيٌّ ينضحُ بالعبقريةِ السرديةِ، لكنه في الوقتِ ذاتِهِ يقطرُ سُمًّا زُعَافًا دُسَّ بعنايةٍ فائقةٍ في عسلِ الحبكةِ المشوقةِ.
تبدأُ الروايةُ ببراعةٍ تحبسُ الأنفاسَ، واصفةً رحلةَ الشابِّ ابنِ طاهرٍ إلى قلعةِ ألموتَ، مَدْفُوعًا بحماسِ الشبابِ ورغبةِ الانخراطِ في صفوفِ الفدائيينَ. ومنذُ اللحظاتِ الأولى، يدركُ القارئُ أنه لا يدخلُ حِصْنًا عسكريًّا فحسبْ، بل يدخلُ مَصْنَعًا للعقائدِ.
يُقدّمُ لنا بارتولُ شخصيةَ حسنِ الصباحِ لا كداعيةٍ دينيٍّ ورعٍ، بل كنبيٍّ للعدميةِ. إنه يتربعُ على عرشِ القلعةِ كـعنكبوتٍ حاكَ خيوطَهُ بمهارةٍ حولَ فريستِـهِ الكبرى: العقلِ البشريِّ. الصباحُ في الروايةِ هو تجسيدٌ لـلميكافيليةِ المطلقةِ، رجلٌ أدركُ بذكاءٍ شيطانيٍّ أنَّ مفاتيحَ السيطرةِ على البشرِ ليستْ في السلاسلِ والأغلالِ، بل في الخيالِ والرغبةِ.
يصورُ الكاتبُ القلعةَ كمسرحٍ كبيرٍ، والصباحُ هو المخرجُ الذي يقفُ خلفَ الكواليسِ، يحركُ خيوطَ الدمى (أتباعَـهُ) بـبرودِ أعصابٍ لا يضاهى. ولعلَّ أخطرَ ما في هذا التصويرِ هو تجريدُ الصباحِ من أيِّ وازعٍ دينيٍّ حقيقيٍّ، وتحويلُهُ إلى فيلسوفٍ ملحدٍ يرى أنَّ الدينَ مجردُ أفيونٍ ضروريٍّ لترويضِ الجماهيرِ. يقولُ الصباحُ في أحدِ أهمِّ اقتباساتِ الروايةِ كَاشِفًا عن جوهرِ فلسفتِهِ: “لا شيءَ حقيقيٌّ، كلُّ شيءٍ مباحٌ. هذهِ هي الوصيةُ الوحيدةُ التي نتركُها للخاصةِ، أما العامةُ فيجبُ أن يظلوا مقيدينَ بسلاسلِ الشرائعِ والأوهامِ.”
هنا يكمنُ المفتاحُ الأولُ لـفهمِ الروايةِ، إنها ليستْ عنِ الإسلامِ ولا عنِ الإسماعيليةِ، بل هي مرآةٌ تعكسُ صعودَ الفاشيةِ والشموليةِ في أوروبا في ثلاثينياتِ القرنِ العشرينَ، حيثُ القائدُ (السوبرمان) يصنعُ الحقيقةَ للجماهيرِ.
تصلُ الروايةُ إلى ذروتِها الدراميةِ في وصفِ الحدائقِ الخلفيةِ للقلعةِ. هنا يستخدمُ بارتولُ ريشةَ رسامٍ ماهرٍ لرسمِ لوحةٍ حسيةٍ باذخةٍ، أنهارٍ من خمرٍ وعسلٍ، جوارٍ حسناواتٍ (حورِ العينِ)، ومخدرِ الحشيشِ الذي يغيبُ الوعيَ.
هذا الجزءُ من الروايةِ هو العسلُ الذي يجذبُ القارئَ. الوصفُ دقيقٌ وساحرٌ، يجعلُك تشمُّ عبقَ الزهورِ وتسمعُ خريرَ المياهِ. لكنَّ بارتولَ يستخدمُ هذا الجمالَ لغرضٍ خبيثٍ، فهو يريدُ ترسيخَ الأسطورةِ القائلةِ بأنَّ الإيمانَ لا يمكنُ أن ينبعَ من قناعةٍ عقليةٍ أو روحيةٍ، بل هو نتاجُ غريزةٍ وشهوةٍ.
يتمُّ تخديرُ ابنِ طاهرٍ ورفاقِهِ، ويُنقلون إلى هذهِ الحدائقِ وهم نيامٌ، ليستيقظوا ويظنوا أنهم قد ماتوا ودخلوا الجنةَ. هذهِ الخدعةُ المسرحيةُ، رغمَ عدمِ ثبوتِها تَارِيخِيًّا، وظفَها الكاتبُ ببراعةٍ لتمريرِ فكرةِ أنَّ اليقينَ سلعةٌ قابلةٌ للصناعةِ. فالفدائيُّ لا يضحي بنفسِهِ من أجلِ اللهِ، بل من أجلِ العودةِ إلى تلكَ اللذةِ الحسيةِ التي ذاقَها. إنه اختزالٌ ماديٌّ فجٌّ للروحانيةِ، وتسقيطٌ لقيمةِ التضحيةِ.
رأيي في الرواية
بارتولُ لا يكتفي بجعلِ الصباحِ دجالاً، بل يجعلُـهُ ينظّرُ لدجلِهِ عبرَ مقارنةِ نفسِهِ بالأنبياءِ، وعلى رأسِهم النبيُّ محمدٌ (ص). ففي حواراتٍ مطولةٍ داخلَ الروايةِ، يطرحُ بارتول على لسان الصباحِ فكرةَ أنَّ الأنبياءَ جَمِيعًا كانوا مجردَ عباقرةٍ سياسيينَ أدركوا حاجةَ البشرِ إلى خرافةٍ توحدُهم، فاخترعوا لـهم الدينَ.
هذا هو السمُّ الزعافُ. الكاتبُ بارتولُ يمررُ للقارئِ - خاصةً القارئَ الغربيَّ أو غيرَ المطلعِ - فكرةَ أنَّ الرسالةَ المحمديةَ التي غيرتْ وجهَ التاريخِ وأخرجتِ الناسَ من الظلماتِ إلى النورِ، وحررتِ العقولَ من عبادةِ الأصنامِ، هي في جوهرِها مشابهةٌ لمشروعِ حسنِ الصباحِ القائمِ على التخديرِ والخداعِ.
إنه خلطٌ متعمدٌ بين الوحيِ السماويِّ الذي جاءَ بالصدقِ والأمانةِ والزهدِ الحقيقيِّ، وبين الإيحاءِ النفسيِّ الذي مارسَهُ الصباحُ. فالنبيُّ محمدٌ (ص) بنى أمةً على التقوى والتعقلِ، بينما الصباحُ في الروايةِ بنى عصابةً على الهلوسةِ والتبعيةِ العمياءِ.
يقولُ الصباحُ مُبَرِّرًا خداعَهُ لأتباعِهِ: “الناسُ لا يريدون الحقيقةَ العاريةَ، إنـها تحرقُ عيونَهم. هم يريدون حِجَابًا جَمِيلًا من الأوهامِ يسترُ عنهم فراغَ الكونِ.”
هذهِ العبارةُ تلخصُ نظرةَ بارتولَ الاستعلائيةَ على البشريةِ، وهي نظرةٌ تتناقضُ كُلِّيًّا مع جوهرِ النبوةِ التي جاءتْ لتكريمِ الإنسانِ لا لاحتقارِهِ.
أَدَبِيًّا، الروايةُ تحفةٌ فنيةٌ في بناءِ الشخصياتِ وتصاعدِ الأحداثِ. التحولُ في شخصيةِ ابنِ طاهرٍ من مؤمنٍ ساذجٍ إلى منتقمٍ يائسٍ، ثم إلى عدميٍّ محطمٍ، هو دراسةٌ نفسيةٌ مذهلةٌ. لكنْ تَارِيخِيًّا، الروايةُ جنايةٌ كاملةُ الأركانِ.
لقد أخذَ بارتولُ إشاعاتِ الرحالةِ وأكاذيبَ الخصومِ، وبنى عليها صَرْحًا شَاهِقًا من اليقينِ الزائفِ. لا يوجدُ دليلٌ تاريخيٌّ واحدٌ، لا في المصادرِ الإسلاميةِ (سنيةٍ أو شيعيةٍ) ولا في الآثارِ المكتشفةِ، يثبتُ وجودَ تلكَ الحدائقِ أو استخدامَ الحشيشِ بهذهِ الطريقةِ المسرحيةِ.
إنَّ الروايةَ، بهذا المعنى، تمارسُ نفسَ ما يمارسُهُ بطلُها: صناعةَ حقيقةٍ بديلةٍ. فـكما خدعَ الصباحُ أتباعَهُ بالجنةِ المزيفةِ، خدعَ بارتولُ قراءَهُ بالتاريخِ المزيفِ. لقد جعلَ من الأسطورةِ حقيقةً دامغةً في الوعيِ الجمعيِّ العالميِّ، لدرجةِ أنَّ الكثيرينَ اليومَ يعتقدون أنَّ هذهِ هي القصةُ الحقيقيةُ لـلحشاشينَ.
روايةُ ألموتَ تشبهُ إلى حدٍّ بعيدٍ الحديقةَ التي وصفتْها، جميلةً، ساحرةً، تغري بالبقاءِ فيـها، لكنها مسكونةٌ بالأفاعي. إنها عملٌ يستحقُّ القراءةَ لسببينِ متناقضينِ: للاستمتاعِ بأسلوبٍ أدبيٍّ رفيعٍ وقدرةٍ فذةٍ على سبرِ أغوارِ النفسِ البشريةِ المظلمةِ. ولكشفِ آلياتِ الدعايةِ السوداءَ وكيفَ يمكنُ للأدبِ أن يُستخدمَ لتشويهِ التاريخِ ومساواةِ الثرى بالثريا.
الخلاصة
على القارئِ أن يمسكَ بهذهِ الروايةِ وهو يرتدي قفازاتٍ من الوعيِ النقديِّ، مُدْرِكًا أنَّ ما بين يديهِ ليس تَارِيخًا للإسماعيليةِ أو الإسلامِ، بل هو مرثيةٌ أوروبيةٌ للقيمِ، ألبسَها الكاتبُ ثِيَابًا شرقيةً، وحاولَ فيها عَبَثًا أن ينزلَ الأنبياءَ من عليائهم ليجلسَـهم بجوارِ الطغاةِ والمخادعينَ. إنَّ ألموتَ بارتولَ هي قصةٌ عن قوةِ الكذبةِ، وليستْ عن حقيقةِ التاريخِ.